عمدت البلدان العربية تدريجياً إلى توسيع فرص الحصول على التعليم وتقليص الفوارق بين الجنسين في التعليم منذ عام 2000. إلا أن انعدام المساواة وتفاوت الجودة في التدريس لا يزال يعيق التقدم في أهداف التنمية المستدامة، ويؤثر على الطلاب من جميع مشارب الحياة. وتواجه نُظُم تعليمية عديدة صعوبات في تقديم الخدمة الكافية للطلاب الفقراء، والمجتمعات الريفية، والفتيات والنساء، واللاجئين، والنازحين داخلياً، والأشخاص ذوي الإعاقة، ما يؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة ويقيّد التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتحتاج البلدان العربية لإحراز التقدم المطلوب على مسار الهدف 4 (التعليم الجيد) إلى وضع سياسات كليّة وواضحة ومزوّدة بما يكفي من الموارد لتحسين نوعية وملاءمة نتائج التعلّم، وإصلاح المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم. فالسياسات التي تعزّز التفكير النقدي لدى الطلاب وتكسبهم المهارات ضرورية لبلوغ الهدف 4 ولتزويد الطلاب بما يلزم للنجاح في المدرسة والعمل والحياة، انطلاقاً من الإلمام بالمبادئ الأساسية للقراءة والكتابة والحساب وحل المشاكل، وتنمية الكفاءات الفنية والمهنية، وغيرها من المهارات الحياتية الأساسية.



 أقرّت جميع البلدان تقريباً في القانون الحق في التعليم، مجانياً وإلزامياً من القطاع العام. وينصّ الدستور في 19 دولة عربية على أن التعليم مسؤولية تقع على عاتق الدولة، إلاّ أنّه لا يقرّ به كحقّ في جميع هذه البلدان. وتتراوح إلزامية التعليم بين ست سنوات في جزر القمر والعراق و12 سنة في الإمارات العربية المتحدة ومصر3 .
أقرّت جميع البلدان تقريباً في القانون الحق في التعليم، مجانياً وإلزامياً من القطاع العام. وينصّ الدستور في 19 دولة عربية على أن التعليم مسؤولية تقع على عاتق الدولة، إلاّ أنّه لا يقرّ به كحقّ في جميع هذه البلدان. وتتراوح إلزامية التعليم بين ست سنوات في جزر القمر والعراق و12 سنة في الإمارات العربية المتحدة ومصر3 .  عمدت البلدان إلى إصلاح المناهج الدراسية وزيادة مؤهّ ات المعلمين
لتحسين نوعية التعليم. وأبرزَ تحليل أجري حديثاً تناول 18 خطة تعليمية
وطنية في المنطقة العربية 4 أن 15 منها تركّز على تحسين نوعية التدريس، فيما
تتضمّن 17 خطة بنوداً تُعنى بتحسين مؤهلات المعلمين ومهاراتهم، وتوسيع فرص
تطوّرهم المهني، أو تقليل نسبة الطلاب إلى المعلمين. وشملت إصلاحات المناهج
الدراسية مجموعة من التدابير لتحسين نتائج التعلّم، مثل توحيد المعايير الوطنية،
والتشديد على المواد التي تعتبر مهمة لنجاح الطلاب (مثل العلوم والتكنولوجيا،
أمّ العلوم الإنسانية والفنون فلم يطلها سوى القليل من الإصلاحات)، والتركيز على
المهارات الحياتية الهامة مثل الإبداع وحل المشاكل. واستُخدمت أدوات مثل أُطُر
التأهيل من أجل تعزيز اتساق نوعية التعليم ونتائج الطلاب.
عمدت البلدان إلى إصلاح المناهج الدراسية وزيادة مؤهّ ات المعلمين
لتحسين نوعية التعليم. وأبرزَ تحليل أجري حديثاً تناول 18 خطة تعليمية
وطنية في المنطقة العربية 4 أن 15 منها تركّز على تحسين نوعية التدريس، فيما
تتضمّن 17 خطة بنوداً تُعنى بتحسين مؤهلات المعلمين ومهاراتهم، وتوسيع فرص
تطوّرهم المهني، أو تقليل نسبة الطلاب إلى المعلمين. وشملت إصلاحات المناهج
الدراسية مجموعة من التدابير لتحسين نتائج التعلّم، مثل توحيد المعايير الوطنية،
والتشديد على المواد التي تعتبر مهمة لنجاح الطلاب (مثل العلوم والتكنولوجيا،
أمّ العلوم الإنسانية والفنون فلم يطلها سوى القليل من الإصلاحات)، والتركيز على
المهارات الحياتية الهامة مثل الإبداع وحل المشاكل. واستُخدمت أدوات مثل أُطُر
التأهيل من أجل تعزيز اتساق نوعية التعليم ونتائج الطلاب.  زادت البلدان من استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية. ويعدّ التركيز المتزايد على المعرفة التكنولوجية وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات جزءاً من الجهد الرامي إلى ضمان تزويد الطلاب بالمهارات الكافية لتحقيق النجاح في اقتصاد القرن الحادي والعشرين. وبناءً على ذلك، يعمد العديد من البلدان إلى إدراج برامج جديدة ضمن تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتخصيص المزيد من الوقت لهذه المواد في المناهج الدراسية العادية، وتعزيز المؤسسات التقنية والمهنية المتخصصة في هذه المواضيع. وشمل هذا التركيز المتزايد على التكنولوجيا التوسع في برامج وأدوات التعلّم الإلكتروني بحيث تغدو النُّظُم التعليمية أكثر مرونة، وأوسع انتشاراً، وأقوى منعة، وقد تسارعت هذه العملية أثناء جائحة كوفيد-19. غير أن الجهود الرامية إلى تنفيذ هذه الحلول معرّضة لمخاطر الفجوات الرقمية المستمرة. وأتاح التحوّل إلى التعلّم الإلكتروني أثناء الجائحة استمرارية التعلّم، لكنه أهمل ملايين الطلاب. وتشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من الطلاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم يتمكنوا من الاستفادة من برامج التعليم عن بعد بسبب غياب البرامج الملائمة أو الافتقار إلى الأدوات اللازمة للوصول إلى طرق التعلّم البديلة (كالكهرباء، أو الإنترنت، أو توفّر الحاسوب في المنزل) 5. وتُبرز هذه التجربة ضرورة زيادة الاستثمار في البنية الأساسية الرقمية لتعزيز منعة النُّظُم التعليمية إزاء الأزمات. ولمعرفة المزيد عن تحليل مخاطر الفجوات الرقمية، يمكن الاطلاع على الفصل الخاص بالهدف 17.
زادت البلدان من استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية. ويعدّ التركيز المتزايد على المعرفة التكنولوجية وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات جزءاً من الجهد الرامي إلى ضمان تزويد الطلاب بالمهارات الكافية لتحقيق النجاح في اقتصاد القرن الحادي والعشرين. وبناءً على ذلك، يعمد العديد من البلدان إلى إدراج برامج جديدة ضمن تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتخصيص المزيد من الوقت لهذه المواد في المناهج الدراسية العادية، وتعزيز المؤسسات التقنية والمهنية المتخصصة في هذه المواضيع. وشمل هذا التركيز المتزايد على التكنولوجيا التوسع في برامج وأدوات التعلّم الإلكتروني بحيث تغدو النُّظُم التعليمية أكثر مرونة، وأوسع انتشاراً، وأقوى منعة، وقد تسارعت هذه العملية أثناء جائحة كوفيد-19. غير أن الجهود الرامية إلى تنفيذ هذه الحلول معرّضة لمخاطر الفجوات الرقمية المستمرة. وأتاح التحوّل إلى التعلّم الإلكتروني أثناء الجائحة استمرارية التعلّم، لكنه أهمل ملايين الطلاب. وتشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من الطلاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم يتمكنوا من الاستفادة من برامج التعليم عن بعد بسبب غياب البرامج الملائمة أو الافتقار إلى الأدوات اللازمة للوصول إلى طرق التعلّم البديلة (كالكهرباء، أو الإنترنت، أو توفّر الحاسوب في المنزل) 5. وتُبرز هذه التجربة ضرورة زيادة الاستثمار في البنية الأساسية الرقمية لتعزيز منعة النُّظُم التعليمية إزاء الأزمات. ولمعرفة المزيد عن تحليل مخاطر الفجوات الرقمية، يمكن الاطلاع على الفصل الخاص بالهدف 17.  يشكل تحقيق المساواة بين الجنسين وإدماج الإعاقة في التعليم أولوية في معظم البلدان، إلا أن انعدام المساواة لا يزال مستمراً. وقد أحرزت المنطقة تقدماً ملحوظاً، إذ قلّصت الفوارق بين الجنسين في مجموع الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي من 12 إلى 5 في المائة بين عامي 2000 و2020، إلاّ أن الفوارق لا تزال أعلى من المتوسط العالمي البالغ 1 في المائة.6 وتعيق الأعراف الاجتماعية والثقافية فرص حصول الفتيات على التعليم على الرغم من ازدياد التحاقهن بالمدارس. وتتسع الفوارق في مستويات التعليم الأعلى، ولا سيما في صفوف النساء والفتيات الفقيرات في المناطق الريفية. وغالباً ما تشمل التحديات التي تقوّض فرص تعليم الفتيات إعطاء الآباء الأولويّة لأطفالهم الذكور في استشراف الآفاق الاقتصادية، ونقص المدرّسات، والمخاوف بشأن سلامة الوصول إلى المدرسة، والزواج المبكر. وتتفاقم هذه المشاكل في البلدان المتأثرة بالصراعات، حيث الفتيات أكثر عرضة لعدم الالتحاق بالمدارس بمقدار 2.5 أضعاف مقارنة بالفتيان.7
يشكل تحقيق المساواة بين الجنسين وإدماج الإعاقة في التعليم أولوية في معظم البلدان، إلا أن انعدام المساواة لا يزال مستمراً. وقد أحرزت المنطقة تقدماً ملحوظاً، إذ قلّصت الفوارق بين الجنسين في مجموع الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي من 12 إلى 5 في المائة بين عامي 2000 و2020، إلاّ أن الفوارق لا تزال أعلى من المتوسط العالمي البالغ 1 في المائة.6 وتعيق الأعراف الاجتماعية والثقافية فرص حصول الفتيات على التعليم على الرغم من ازدياد التحاقهن بالمدارس. وتتسع الفوارق في مستويات التعليم الأعلى، ولا سيما في صفوف النساء والفتيات الفقيرات في المناطق الريفية. وغالباً ما تشمل التحديات التي تقوّض فرص تعليم الفتيات إعطاء الآباء الأولويّة لأطفالهم الذكور في استشراف الآفاق الاقتصادية، ونقص المدرّسات، والمخاوف بشأن سلامة الوصول إلى المدرسة، والزواج المبكر. وتتفاقم هذه المشاكل في البلدان المتأثرة بالصراعات، حيث الفتيات أكثر عرضة لعدم الالتحاق بالمدارس بمقدار 2.5 أضعاف مقارنة بالفتيان.7 
 يتزايد اهتمام البلدان بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وبالرغم من ارتفاع معدلات الالتحاق في المنطقة إلى 46.1 في المائة، لا تزال متدنيّة مقارنة بالمناطق الأخرى. ومن الأمثلة على إعطاء الأولوية للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة:
يتزايد اهتمام البلدان بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وبالرغم من ارتفاع معدلات الالتحاق في المنطقة إلى 46.1 في المائة، لا تزال متدنيّة مقارنة بالمناطق الأخرى. ومن الأمثلة على إعطاء الأولوية للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة:  إعداد منهج دراسي لمرحلة التعليم ما قبل الابتدائي في فلسطين.
إعداد منهج دراسي لمرحلة التعليم ما قبل الابتدائي في فلسطين.  إنشاء إدارات مخصصة ضمن وزارات التعليم في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر.
إنشاء إدارات مخصصة ضمن وزارات التعليم في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر. وضع استراتيجيات لتشجيع الالتحاق في الأردن، وتونس، والسودان، والكويت، والمغرب.
وضع استراتيجيات لتشجيع الالتحاق في الأردن، وتونس، والسودان، والكويت، والمغرب.إلاّ أنّ التعليم ما قبل الابتدائي يبقى غير إلزامي في جميع البلدان العربية. ووحدها الجزائر تقدّم سنة من التعليم المجاني في هذه المرحلة 10 . ويشكل عدم مجانية التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة عائقاً كبيراً أمام فرص الحصول عليه، لا سيما في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الفقر.
 وضعت البلدان سياسات للتعليم العالي، مع التركيز على فرص الحصول عليه وعلى تحسين نوعيته. فالالتحاق بالجامعات الحكومية مجاني أو شبه مجاني للطلاب المواطنين في العديد من البلدان العربية. وتقدّم الحكومات مجموعة من المنح الدراسية ومساعدات لتأمين السكن ووجبات الطعام بهدف دعم الطلاب في الحصول على التعليم ما بعد المرحلة الثانوية. وتختلف نُظُم التعليم العالي في عدد من البلدان باختلاف الجامعات بين عامة وخاصة وتقنية ودولية.
وضعت البلدان سياسات للتعليم العالي، مع التركيز على فرص الحصول عليه وعلى تحسين نوعيته. فالالتحاق بالجامعات الحكومية مجاني أو شبه مجاني للطلاب المواطنين في العديد من البلدان العربية. وتقدّم الحكومات مجموعة من المنح الدراسية ومساعدات لتأمين السكن ووجبات الطعام بهدف دعم الطلاب في الحصول على التعليم ما بعد المرحلة الثانوية. وتختلف نُظُم التعليم العالي في عدد من البلدان باختلاف الجامعات بين عامة وخاصة وتقنية ودولية.  يتصدّى العديد من البلدان لاستمرار الارتفاع في معدلات بطالة الشباب بسياسات تركز على تعزيز التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني وبناء الشراكات مع القطاع الخاص، سعياً منها إلى ضمان ملاءمة المهارات المكتسبة في المدارس مع احتياجات أصحاب العمل . ولهذه السياسات دور رئيسي في تسهيل عمليات الانتقال من التعلّم إلى الكسب التي تمكّن الخريجين الشباب من الحصول على عمل لائق، وفي تقليص العدد الكبير من الشباب الذين هم خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب. ففي عام 2022، بلغ تعداد هذه الفئة 30.7 في المائة من مجموع الشباب في المنطقة و42.9 في المائة من الشابات، ما يشير إلى الحاجة الملحّة لتوفير فرص عمل للشباب. للحصول على معلومات إضافية عن هذا الموضوع، يمكن الاطلاع على الفصل الخاص بالهدف 8.
يتصدّى العديد من البلدان لاستمرار الارتفاع في معدلات بطالة الشباب بسياسات تركز على تعزيز التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني وبناء الشراكات مع القطاع الخاص، سعياً منها إلى ضمان ملاءمة المهارات المكتسبة في المدارس مع احتياجات أصحاب العمل . ولهذه السياسات دور رئيسي في تسهيل عمليات الانتقال من التعلّم إلى الكسب التي تمكّن الخريجين الشباب من الحصول على عمل لائق، وفي تقليص العدد الكبير من الشباب الذين هم خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب. ففي عام 2022، بلغ تعداد هذه الفئة 30.7 في المائة من مجموع الشباب في المنطقة و42.9 في المائة من الشابات، ما يشير إلى الحاجة الملحّة لتوفير فرص عمل للشباب. للحصول على معلومات إضافية عن هذا الموضوع، يمكن الاطلاع على الفصل الخاص بالهدف 8.أمّا المبادرات الرامية إلى تحسين المواءمة بين نتائج التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني واحتياجات سوق العمل، فتشمل أُطُر المؤهلات الوطنية التي من شأنها ضمان نتائج تعليمية متسقة للخريجين. واعتُمدت هذه الأُطُر في سبعة بلدان هي هي الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، وعُمان، والمغرب، والمملكة العربية السعودية ، ولا تزال في مراحل مختلفة من الإعداد في سبعة بلدان أخرى هي الجزائر، والسودان، والعراق، ودولة فلسطين، وقطر، ولبنان، ومصر . وقد سعت الحكومات إلى تحسين هذه النُّظُم بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف تعزيز قابلية الطلاب للتوظيف.14
 ويشغل التعليم غير النظامي حيّزاً متزايد الأهمية في المنطقة. وهو عبارة عن برامج تعليمية تعدّها منظمة غير حكومية، أو منظمة خاصة، أو فئة مجتمعية خارج إطار التعليم النظامي. ويعدّ التعليم غير النظامي مكمّلاً للتعليم النظامي إذا ما أتاح الفرص لتطوير المهارات المهنية والحياتية. ويتزايد استخدام هذه البرامج في المنطقة. وفي مسح شمل سبعة بلدان، استقطبت برامج تحسين فرص العمل النصيب الأكبر من الاهتمام، ومنها برامج اللغات، ومهارات الكمبيوتر، والرياضيات15. وتشمل سائر البرامج التعليمية غير النظامية التي أُطلقت بدعم من الدولة إعداد دورات دراسية في المجتمعات المحلية لمكافحة الأمية بين الكبار. والأمثلة على هذه البرامج شائعة في المنطقة، وترد في الاستعراضات الوطنية الطوعية لكلّ من الأردن، وتونس، والجزائر، والعراق، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا. وتضطلع المؤسسات الدينية بدور مهم في توفير فرص التعليم، وغالباً ما تدعم الإلمام بالقراءة والكتابة، وأحياناً مجالات أخرى.
ويشغل التعليم غير النظامي حيّزاً متزايد الأهمية في المنطقة. وهو عبارة عن برامج تعليمية تعدّها منظمة غير حكومية، أو منظمة خاصة، أو فئة مجتمعية خارج إطار التعليم النظامي. ويعدّ التعليم غير النظامي مكمّلاً للتعليم النظامي إذا ما أتاح الفرص لتطوير المهارات المهنية والحياتية. ويتزايد استخدام هذه البرامج في المنطقة. وفي مسح شمل سبعة بلدان، استقطبت برامج تحسين فرص العمل النصيب الأكبر من الاهتمام، ومنها برامج اللغات، ومهارات الكمبيوتر، والرياضيات15. وتشمل سائر البرامج التعليمية غير النظامية التي أُطلقت بدعم من الدولة إعداد دورات دراسية في المجتمعات المحلية لمكافحة الأمية بين الكبار. والأمثلة على هذه البرامج شائعة في المنطقة، وترد في الاستعراضات الوطنية الطوعية لكلّ من الأردن، وتونس، والجزائر، والعراق، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا. وتضطلع المؤسسات الدينية بدور مهم في توفير فرص التعليم، وغالباً ما تدعم الإلمام بالقراءة والكتابة، وأحياناً مجالات أخرى. 
 تحلّ بلدان مجلس التعاون الخليجي في الصدارة في تطوير منصات التعلّم الرقمي، وهو اتجاه تسارع خلال جائحة كوفيد-19. وحظيت منصة "مدرستي" في المملكة العربية السعودية على اعتراف دولي بأنها أفضل نظام للتعلّم عن بعد. وتضع مبادرات على غرار منصة "مدرسة" و"المدرسة الرقمية" في دولة الإمارات العربية المتحدة في متناول الطلاب موارد من غير مقابل للتعلّم الإلكتروني في جميع أنحاء المنطقة، مع التركيز على الرياضيات، والعلوم، والبرمجة الحاسوبية.
تحلّ بلدان مجلس التعاون الخليجي في الصدارة في تطوير منصات التعلّم الرقمي، وهو اتجاه تسارع خلال جائحة كوفيد-19. وحظيت منصة "مدرستي" في المملكة العربية السعودية على اعتراف دولي بأنها أفضل نظام للتعلّم عن بعد. وتضع مبادرات على غرار منصة "مدرسة" و"المدرسة الرقمية" في دولة الإمارات العربية المتحدة في متناول الطلاب موارد من غير مقابل للتعلّم الإلكتروني في جميع أنحاء المنطقة، مع التركيز على الرياضيات، والعلوم، والبرمجة الحاسوبية. تعمل بلدان مجلس التعاون الخليجي على إصلاح المناهج وطرق التدريس لتحفيز الطلاب على اكتساب المهارات، وتحسين نتائج التعلّم. وفي جميع هذه البلدان، تعتبر الوثائق الرئيسية للسياسات والرؤى أن التعليم أساسيّ لتسريع توطين القوى العاملة واستخدام اقتصاد المعرفة بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي. وشملت الإصلاحات وضع أو تثبيت المعايير بشأن المناهج القائمة على المهارات (كما هي الحال في والإمارات العربية المتحدة,22 وعُمان,23 وقطر,24 والكويت25 والمملكة العربية السعودية26), وتعزيز نُظُم المساءلة ومراقبة نوعية التعليم (كما هي الحال في الإمارات العربية المتحدة، وعُمان، والكويت، والمملكة العربية السعودية)، واعتماد نُظُم جديدة لتوظيف أفراد هيئة التدريس وتطويرهم مهنياً (اتخذت هذه الخطوات في في الإمارات العربية المتحدة، وعُمان، وقطر، والكويت، والمملكة العربية السعودية).
تعمل بلدان مجلس التعاون الخليجي على إصلاح المناهج وطرق التدريس لتحفيز الطلاب على اكتساب المهارات، وتحسين نتائج التعلّم. وفي جميع هذه البلدان، تعتبر الوثائق الرئيسية للسياسات والرؤى أن التعليم أساسيّ لتسريع توطين القوى العاملة واستخدام اقتصاد المعرفة بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي. وشملت الإصلاحات وضع أو تثبيت المعايير بشأن المناهج القائمة على المهارات (كما هي الحال في والإمارات العربية المتحدة,22 وعُمان,23 وقطر,24 والكويت25 والمملكة العربية السعودية26), وتعزيز نُظُم المساءلة ومراقبة نوعية التعليم (كما هي الحال في الإمارات العربية المتحدة، وعُمان، والكويت، والمملكة العربية السعودية)، واعتماد نُظُم جديدة لتوظيف أفراد هيئة التدريس وتطويرهم مهنياً (اتخذت هذه الخطوات في في الإمارات العربية المتحدة، وعُمان، وقطر، والكويت، والمملكة العربية السعودية). 
 أطلقت بلدان مجلس التعاون الخليجي العديد من المبادرات لتحسين التكامل بين قطاعاتها التعليمية، لا سيما على مستوى التعليم العالي. وتشمل الخطوات المتخذة الاعتراف المتبادل بالمؤهلات، وإنشاء جامعة الخليج العربي، ودعم برامج تبادل الطلاب والمعلمين، وإطلاق مبادرات البحث والتطوير المشتركة بهدف تحفيز الابتكار وتعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي28.
أطلقت بلدان مجلس التعاون الخليجي العديد من المبادرات لتحسين التكامل بين قطاعاتها التعليمية، لا سيما على مستوى التعليم العالي. وتشمل الخطوات المتخذة الاعتراف المتبادل بالمؤهلات، وإنشاء جامعة الخليج العربي، ودعم برامج تبادل الطلاب والمعلمين، وإطلاق مبادرات البحث والتطوير المشتركة بهدف تحفيز الابتكار وتعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي28.  يُحصّل الطلاب المهاجرون في منطقة بلدان مجلس التعاون الخليجي تعليمهم بشكل أساسي من المؤسسات التعليمية الخاصة التي توفّر لهم نوعية تعليم متفاوتة المستويات. وتشكّل أعداد المهاجرين الكبيرة نحو 52 في المائة من مجموع سكان هذه البلدان29. وتقدّر نسبة أطفال المهاجرين بنحو 25 في المائة من مجموع الأطفال، وهي نسبة ترتفع كل عام. وتفرض معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي رسوم تسجيل أو حصصاً للقبول تحد من فرص التحاق الطلاب المهاجرين بالنظام التعليمي العام، إلا أن البحرين والمملكة العربية السعودية تتيحان الالتحاق مجاناً بالمدارس العامة للأطفال المغتربين القادرين على الدراسة باللغة العربية، والمستوفين شروطاً أخرى. ويلتحق عمليّاً معظم الأطفال المهاجرين في بلدان مجلس التعاون الخليجي بالمدارس الخاصة التي تتبع المناهج الدراسية الدولية.
يُحصّل الطلاب المهاجرون في منطقة بلدان مجلس التعاون الخليجي تعليمهم بشكل أساسي من المؤسسات التعليمية الخاصة التي توفّر لهم نوعية تعليم متفاوتة المستويات. وتشكّل أعداد المهاجرين الكبيرة نحو 52 في المائة من مجموع سكان هذه البلدان29. وتقدّر نسبة أطفال المهاجرين بنحو 25 في المائة من مجموع الأطفال، وهي نسبة ترتفع كل عام. وتفرض معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي رسوم تسجيل أو حصصاً للقبول تحد من فرص التحاق الطلاب المهاجرين بالنظام التعليمي العام، إلا أن البحرين والمملكة العربية السعودية تتيحان الالتحاق مجاناً بالمدارس العامة للأطفال المغتربين القادرين على الدراسة باللغة العربية، والمستوفين شروطاً أخرى. ويلتحق عمليّاً معظم الأطفال المهاجرين في بلدان مجلس التعاون الخليجي بالمدارس الخاصة التي تتبع المناهج الدراسية الدولية. نجحت البلدان المتوسطة الدخل31 في زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس ومتوسط مدة التعليم، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات في تحسين نوعية التعليم الذي تقدمه النُّظُم المدرسية، وتقليص أوجه عدم المساواة المتفاقمة في الحصول عليه. ويقترن النمو السريع في عدد الطلاب بارتفاع مستويات بطالة الشباب، التي يبلغ متوسطها 23 في المائة وتتجاوز 40 في المائة في بعض البلدان، ما حدا هذه البلدان إلى وضع إصلاحات تتوخّى تحسين نتائج التعلّم وتوسيع فرص التشغيل في سوق العمل.
 ركّز العديد من هذه البلدان على تحديث المناهج الدراسية ورفع مستوى تدريب المعلمين لتحسين نتائج تعلّم الطلاب. وتشمل الأهداف المشتركة لإصلاح المناهج الدراسية زيادة التركيز على مجالات التواصل، والإبداع، والتفكير النقدي، وحل المشاكل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وتعزيز التعليم المهني؛ وتطوير المهارات الحياتية (على غرار سياسة التعليم 2.0 في مصر واستراتيجية المدرسة الجزائرية للتعليم في الجزائر).وأنشأ الأردن المركز الوطني لتطوير المناهج في عام 2017 لتقييم وتطوير المواد التعليمية باستمرار بهدف تحسين نتائج تعلّم الطلاب.
ركّز العديد من هذه البلدان على تحديث المناهج الدراسية ورفع مستوى تدريب المعلمين لتحسين نتائج تعلّم الطلاب. وتشمل الأهداف المشتركة لإصلاح المناهج الدراسية زيادة التركيز على مجالات التواصل، والإبداع، والتفكير النقدي، وحل المشاكل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وتعزيز التعليم المهني؛ وتطوير المهارات الحياتية (على غرار سياسة التعليم 2.0 في مصر واستراتيجية المدرسة الجزائرية للتعليم في الجزائر).وأنشأ الأردن المركز الوطني لتطوير المناهج في عام 2017 لتقييم وتطوير المواد التعليمية باستمرار بهدف تحسين نتائج تعلّم الطلاب.  أطلقت البلدان المتوسطة الدخل مبادرات لتوسيع نطاق الحصول على فرص التعليم ليشمل سكّان المناطق المحرومة من الخدمات، مع التركيز على المناطق الريفية والفئات المعرضة لخطر الإهمال. ويسعى المغرب المغرب إلى معالجة أوجه عدم المساواة بين المناطق الحضرية والريفية بإعداد برنامج "المدارس الأهلية" الذي ينشئ مراكز تعليمية للطلاب في الريف تضمّ أفراداً مؤهلين في هيئة التدريس، وتؤمن النقل، وتتيح إمكانية الوصول إلى الإنترنت. ويقدّم برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة الدعم للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في المناطق الريفية عن طريق استحداث أماكن لنحو 15,000 من الأطفال. ووضعت تونس لمعالجة ارتفاع معدلات التسرب مسار "فرصة ثانية" للتعليم الذي يعيد دمج الطلاب في الفصول الدراسية بعد فترة انقطاع عن الدراسة، ويدعم أولئك المعرضين لخطر عدم إتمام التعليم.
أطلقت البلدان المتوسطة الدخل مبادرات لتوسيع نطاق الحصول على فرص التعليم ليشمل سكّان المناطق المحرومة من الخدمات، مع التركيز على المناطق الريفية والفئات المعرضة لخطر الإهمال. ويسعى المغرب المغرب إلى معالجة أوجه عدم المساواة بين المناطق الحضرية والريفية بإعداد برنامج "المدارس الأهلية" الذي ينشئ مراكز تعليمية للطلاب في الريف تضمّ أفراداً مؤهلين في هيئة التدريس، وتؤمن النقل، وتتيح إمكانية الوصول إلى الإنترنت. ويقدّم برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة الدعم للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في المناطق الريفية عن طريق استحداث أماكن لنحو 15,000 من الأطفال. ووضعت تونس لمعالجة ارتفاع معدلات التسرب مسار "فرصة ثانية" للتعليم الذي يعيد دمج الطلاب في الفصول الدراسية بعد فترة انقطاع عن الدراسة، ويدعم أولئك المعرضين لخطر عدم إتمام التعليم.  تكثّف الحكومات جهودها لمواءمة النتائج التعليمية مع احتياجات سوق العمل بهدف زيادة فرص عمل الشباب، وبطرق منها تحسين نُظُم التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني . ففي الجزائر تخضع الجامعات لتقييم نظام ضمان الجودة وفقاً لمعدلات تشغيل خريجيها، ويتزايد فيها وجود مكاتب اتصال تربط الطلاب بأصحاب العمل. وفي الأردن،
تهدف استراتيجية جديدة للتعليم والتدريب التقني والمهني إلى تحفيز تطوير المهارات الوظيفية الأساسية، في حين تؤكد استراتيجية التنمية المستدامة في مصر على دور التعليم الفني في تلبية احتياجات سوق العمل. وفي فلسطين، أُدرج التعليم والتدريب المهني والتقني في المناهج الدراسية للصفوف من السابع إلى التاسع، بهدف تمكين الطلاب في المهارات الحياتية وتعزيز قابلية تشغيلهم. واتخذت جميع البلدان المتوسطة الدخل، باستثناء البلدان المتأثرة بالصراعات أو الأزمات، تدابير لتوحيد نتائج التعلّم، فاعتمدت إطاراً وطنياً للمؤهلات أو شرعت في وضعه. ويتيح التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال ضمان تحسين مواءمة نتائج التعلّم مع احتياجات أصحاب العمل.
تكثّف الحكومات جهودها لمواءمة النتائج التعليمية مع احتياجات سوق العمل بهدف زيادة فرص عمل الشباب، وبطرق منها تحسين نُظُم التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني . ففي الجزائر تخضع الجامعات لتقييم نظام ضمان الجودة وفقاً لمعدلات تشغيل خريجيها، ويتزايد فيها وجود مكاتب اتصال تربط الطلاب بأصحاب العمل. وفي الأردن،
تهدف استراتيجية جديدة للتعليم والتدريب التقني والمهني إلى تحفيز تطوير المهارات الوظيفية الأساسية، في حين تؤكد استراتيجية التنمية المستدامة في مصر على دور التعليم الفني في تلبية احتياجات سوق العمل. وفي فلسطين، أُدرج التعليم والتدريب المهني والتقني في المناهج الدراسية للصفوف من السابع إلى التاسع، بهدف تمكين الطلاب في المهارات الحياتية وتعزيز قابلية تشغيلهم. واتخذت جميع البلدان المتوسطة الدخل، باستثناء البلدان المتأثرة بالصراعات أو الأزمات، تدابير لتوحيد نتائج التعلّم، فاعتمدت إطاراً وطنياً للمؤهلات أو شرعت في وضعه. ويتيح التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال ضمان تحسين مواءمة نتائج التعلّم مع احتياجات أصحاب العمل. 
 تعمل بعض البلدان المتوسطة الدخل على تحسين نوعية التعليم بالعمل على تفعيل إدارة النُّظُم المدرسية من خلال تعزيز عمليات الإبلاغ السنوية، وإنشاء بوابات للبيانات، وإطلاق إصلاحات للتقييم. ومن الأمثلة:
تعمل بعض البلدان المتوسطة الدخل على تحسين نوعية التعليم بالعمل على تفعيل إدارة النُّظُم المدرسية من خلال تعزيز عمليات الإبلاغ السنوية، وإنشاء بوابات للبيانات، وإطلاق إصلاحات للتقييم. ومن الأمثلة:
 أطلقت الجزائر نظاماً وطنياً للمعلومات في عام 2017 لدعم إدارة النظام التعليمي، يتضمن وحدات للتقييم، والموارد البشرية، والبنية الأساسية، والتعلّم عن بعد، وغير ذلك.
أطلقت الجزائر نظاماً وطنياً للمعلومات في عام 2017 لدعم إدارة النظام التعليمي، يتضمن وحدات للتقييم، والموارد البشرية، والبنية الأساسية، والتعلّم عن بعد، وغير ذلك. أطلقت تونس نظاماً جديداً للتقييم في عام 2021 من شأنه جمع معلومات عن نتائج تعلّم الطلاب في الصفوف الثاني والرابع والسادس.
أطلقت تونس نظاماً جديداً للتقييم في عام 2021 من شأنه جمع معلومات عن نتائج تعلّم الطلاب في الصفوف الثاني والرابع والسادس. وتعدّ الأردن، وتونس، ودولة فلسطين، ومصر، والمغرب ، من بين البلدان القليلة في المنطقة التي تنشر بانتظام تقريراً وطنياً لرصد التعليم.32
وتعدّ الأردن، وتونس، ودولة فلسطين، ومصر، والمغرب ، من بين البلدان القليلة في المنطقة التي تنشر بانتظام تقريراً وطنياً لرصد التعليم.32 تضمّ البلدان العربية المتوسطة الدخل أكثر من 8 مليون لاجئ وطالب لجوء، أي أكثر من 85 في المائة من مجموع هؤلاء في المنطقة، وحوالي ربع المجموع العالمي. وقد أطلقت مجموعة من الاستجابات لتلبية الاحتياجات التعليمية للأطفال اللاجئين في سن الدراسة واعتمدت تونس، والجزائر، والمغرب سياسات تتيح للطلاب اللاجئين من فئات عمرية محددة الالتحاق بالمدارس العامة من غير مقابل. وفي مصر، يُسمح للطلاب اللاجئين من الجمهورية العربية السورية، وجنوب السودان، والسودان، واليمن، الالتحاق بالمدارس العامة، شأنهم شأن الطلاب المحليين. ولا يزال بعض اللاجئين يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات على الرغم من تمتّعهم بهذه الحقوق القانونية في التعليم، وذلك بسبب العوائق والإجراءات الإدارية، أو لعدم قدرتهم على الدراسة باللغة العربية. وفي الأردن الذي يضم أكثر من 3 مليون لاجئ فلسطيني وسوري، يحصل الأطفال اللاجئون في سن الدراسة على فرص التعليم عبر سبل شتى، منها مدارس للفلسطينيين تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والمدارس العامة في المجتمعات المضيفة (التي تعتمد أحياناً نظام الدوامين) والمدارس التي أنشئت في مخيمات اللاجئين 33 . ولم يصدّق لبنان على اتفاقية الأمم المتحدة وبروتوكولها بشأن وضع اللاجئين، وتتوفر فيه نُظُم مختلفة يحصل بموجبها اللاجئون الفلسطينيون وغيرهم (وأغلبهم من السوريين) على فرص التعليم. ويتلقى غالبية الطلاب الفلسطينيين تعليمهم في مدارس الأونروا، لأن القانون اللبناني لا يتيح لهم الاستفادة من التعليم الرسمي. أمّا الذين يتعذّر عليهم الوصول إلى مدارس الأونروا، فيخضعون للشروط التي تحددها التعاميم السنوية بشأن إمكانية التحاقهم بالمدارس العامة. وقد التحق حوالي نصف الطلاب السوريين بالتعليم الرسمي، بحيث يؤمّن العديد من المدارس دواماً ثانياً في فترة بعد الظهر لحوالي 65 في المائة من هؤلاء السكان.
تضمّ البلدان العربية المتوسطة الدخل أكثر من 8 مليون لاجئ وطالب لجوء، أي أكثر من 85 في المائة من مجموع هؤلاء في المنطقة، وحوالي ربع المجموع العالمي. وقد أطلقت مجموعة من الاستجابات لتلبية الاحتياجات التعليمية للأطفال اللاجئين في سن الدراسة واعتمدت تونس، والجزائر، والمغرب سياسات تتيح للطلاب اللاجئين من فئات عمرية محددة الالتحاق بالمدارس العامة من غير مقابل. وفي مصر، يُسمح للطلاب اللاجئين من الجمهورية العربية السورية، وجنوب السودان، والسودان، واليمن، الالتحاق بالمدارس العامة، شأنهم شأن الطلاب المحليين. ولا يزال بعض اللاجئين يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات على الرغم من تمتّعهم بهذه الحقوق القانونية في التعليم، وذلك بسبب العوائق والإجراءات الإدارية، أو لعدم قدرتهم على الدراسة باللغة العربية. وفي الأردن الذي يضم أكثر من 3 مليون لاجئ فلسطيني وسوري، يحصل الأطفال اللاجئون في سن الدراسة على فرص التعليم عبر سبل شتى، منها مدارس للفلسطينيين تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والمدارس العامة في المجتمعات المضيفة (التي تعتمد أحياناً نظام الدوامين) والمدارس التي أنشئت في مخيمات اللاجئين 33 . ولم يصدّق لبنان على اتفاقية الأمم المتحدة وبروتوكولها بشأن وضع اللاجئين، وتتوفر فيه نُظُم مختلفة يحصل بموجبها اللاجئون الفلسطينيون وغيرهم (وأغلبهم من السوريين) على فرص التعليم. ويتلقى غالبية الطلاب الفلسطينيين تعليمهم في مدارس الأونروا، لأن القانون اللبناني لا يتيح لهم الاستفادة من التعليم الرسمي. أمّا الذين يتعذّر عليهم الوصول إلى مدارس الأونروا، فيخضعون للشروط التي تحددها التعاميم السنوية بشأن إمكانية التحاقهم بالمدارس العامة. وقد التحق حوالي نصف الطلاب السوريين بالتعليم الرسمي، بحيث يؤمّن العديد من المدارس دواماً ثانياً في فترة بعد الظهر لحوالي 65 في المائة من هؤلاء السكان.  أدرجت عدة بلدان التعليم ضمن نُظُم الحماية الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، يتضمن كل من البرنامج الوطني للتضامن الأسري في جيبوتي، والبرنامج الوطني "تكافل" للمخصصات الاجتماعية في موريتانيا بنوداً تربط الدعم المقدم بشرط استيفاء المتطلبات الصحية للأطفال ومواظبتهم على الدراسة. وتشمل الأمثلة الأخرى برنامج شامل في السودان، الذي يقدم مجموعة متنوعة من المستحقات للمجتمعات المؤهلة، بما في ذلك برنامج التغذية المدرسية للطلاب المؤهلين. ويضع أيضاً كل من جيبوتي وموريتانيا برامج للتغذية المدرسية بهدف تشجيع الطلاب على الحصول على التعليم.
أدرجت عدة بلدان التعليم ضمن نُظُم الحماية الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، يتضمن كل من البرنامج الوطني للتضامن الأسري في جيبوتي، والبرنامج الوطني "تكافل" للمخصصات الاجتماعية في موريتانيا بنوداً تربط الدعم المقدم بشرط استيفاء المتطلبات الصحية للأطفال ومواظبتهم على الدراسة. وتشمل الأمثلة الأخرى برنامج شامل في السودان، الذي يقدم مجموعة متنوعة من المستحقات للمجتمعات المؤهلة، بما في ذلك برنامج التغذية المدرسية للطلاب المؤهلين. ويضع أيضاً كل من جيبوتي وموريتانيا برامج للتغذية المدرسية بهدف تشجيع الطلاب على الحصول على التعليم. في معظم الحالات، حاولت أقل البلدان نمواً زيادة كفاءة الإنفاق باستخدام الاستهداف الجغرافي للتركيز على المناطق التي تفتقر إلى خدمات النُّظُم التعليمية الوطنية. وأعطت خطط الحماية الاجتماعية الأولوية للمناطق والمجتمعات المحلية التي تسجّل أعلى مستويات من الفقر. وتركز مبادرة المناطق ذات الأولوية التربويّة في موريتانيا على دعم المناطق التي ترتفع فيها معدلات الفقر وتنخفض معدلات إتمام الدراسة، وتشمل هذه المبادرة إعداد برامج الوجبات، وتدريب المعلمين، ووضع نُظُم الحوافز، وإطلاق حملات تثقيف الأهل، وتنمية القدرات.
في معظم الحالات، حاولت أقل البلدان نمواً زيادة كفاءة الإنفاق باستخدام الاستهداف الجغرافي للتركيز على المناطق التي تفتقر إلى خدمات النُّظُم التعليمية الوطنية. وأعطت خطط الحماية الاجتماعية الأولوية للمناطق والمجتمعات المحلية التي تسجّل أعلى مستويات من الفقر. وتركز مبادرة المناطق ذات الأولوية التربويّة في موريتانيا على دعم المناطق التي ترتفع فيها معدلات الفقر وتنخفض معدلات إتمام الدراسة، وتشمل هذه المبادرة إعداد برامج الوجبات، وتدريب المعلمين، ووضع نُظُم الحوافز، وإطلاق حملات تثقيف الأهل، وتنمية القدرات.  قد ركزت البلدان على زيادة معايير تدريب المعلمين في إطار جهد أوسع نطاقاً لتحسين نوعية التعليم واعتمدت الصومال سياسة جديدة للمعلمين في عام 2021 تعنى بتسجيلهم، ومنحهم رخص عمل، وتوظيفهم، وتوزيعهم على مراكز عملهم، وتنظيم سلوكهم. وفي موريتانيا يشجع صندوق دعم التطوير المهني المعلمين على مواصلة اكتساب المهارات، ويقدم برنامج التدريب الوطني للمعلمين في السودان السودان دورات تدريبية مستمرّة لتحسين مؤهلاتهم أثناء الخدمة. وشددت جيبوتي على تدريب المعلمين، وأبلغت أن جميع المعلمين في المدارس العامة يحظون بالمؤهلات اللازمة، باستثناء المعلمين في مرحلة ما قبل الروضة.
قد ركزت البلدان على زيادة معايير تدريب المعلمين في إطار جهد أوسع نطاقاً لتحسين نوعية التعليم واعتمدت الصومال سياسة جديدة للمعلمين في عام 2021 تعنى بتسجيلهم، ومنحهم رخص عمل، وتوظيفهم، وتوزيعهم على مراكز عملهم، وتنظيم سلوكهم. وفي موريتانيا يشجع صندوق دعم التطوير المهني المعلمين على مواصلة اكتساب المهارات، ويقدم برنامج التدريب الوطني للمعلمين في السودان السودان دورات تدريبية مستمرّة لتحسين مؤهلاتهم أثناء الخدمة. وشددت جيبوتي على تدريب المعلمين، وأبلغت أن جميع المعلمين في المدارس العامة يحظون بالمؤهلات اللازمة، باستثناء المعلمين في مرحلة ما قبل الروضة.  تفتقر أقل البلدان نمواً إلى تنسيق معايير القياس والإبلاغ، ولا يعتمد أي من البلدان التي شملها المسح إطاراً وطنياً للرصد والإبلاغ للنظم التعليمية. ولذلك، تنقصها البيانات المفصلة اللازمة لتوجيه إصلاحات السياسات القائمة على الأدلة، وزيادة كفاءة تخصيص الموارد. وسعت جزر القمر إلى سد هذا النقص بإعداد مشروع التعليم الانتقالي الذي يتوخى تحسين الاستخدام الوطني للبيانات من خلال وضع حوليات إحصائية تشمل تجريبياً 50 مدرسة. وتهدف الإصلاحات الشاملة لنُظُم إدارة المعلومات في الصومال وموريتانيا إلى تعزيز جمع البيانات.34
تفتقر أقل البلدان نمواً إلى تنسيق معايير القياس والإبلاغ، ولا يعتمد أي من البلدان التي شملها المسح إطاراً وطنياً للرصد والإبلاغ للنظم التعليمية. ولذلك، تنقصها البيانات المفصلة اللازمة لتوجيه إصلاحات السياسات القائمة على الأدلة، وزيادة كفاءة تخصيص الموارد. وسعت جزر القمر إلى سد هذا النقص بإعداد مشروع التعليم الانتقالي الذي يتوخى تحسين الاستخدام الوطني للبيانات من خلال وضع حوليات إحصائية تشمل تجريبياً 50 مدرسة. وتهدف الإصلاحات الشاملة لنُظُم إدارة المعلومات في الصومال وموريتانيا إلى تعزيز جمع البيانات.34 اعتمدت بعض البلدان المتأثرة بالصراعات خططاً تعليمية انتقالية تتوخّى معالجة مخلّفات الصراع بطريقة مباشرة، والتعافي من الاضطرابات المتفاقمة. وتغطي هذه الخطط الحاجة إلى إصلاح البنية الأساسية، وإعادة إنشاء أو تعزيز إدارة وتنظيم النُّظُم التعليمية، واقتراح حلول توفّر فرص التعليم البديل لأعداد كبيرة من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس ومسارات لإعادة دمجهم، وتعالج النقص في أفراد هيئة التدريس المؤهلين، وتقدّم دعماً إضافياً (بما في ذلك التعلّم الاجتماعي والعاطفي) لتهيئة بيئات تعليمية آمنة. ومن الأمثلة على هذه السياسات الاستراتيجية الوطنية العراقية للتربية والتعليم (2022-2031)، والخطة الوطنية لقطاع التعليم في الصومال (2022-2026)، والخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع التعليم في السودان (2018-2023)، وخطة التعليم الانتقالية في اليمن (2019–2022).
اعتمدت بعض البلدان المتأثرة بالصراعات خططاً تعليمية انتقالية تتوخّى معالجة مخلّفات الصراع بطريقة مباشرة، والتعافي من الاضطرابات المتفاقمة. وتغطي هذه الخطط الحاجة إلى إصلاح البنية الأساسية، وإعادة إنشاء أو تعزيز إدارة وتنظيم النُّظُم التعليمية، واقتراح حلول توفّر فرص التعليم البديل لأعداد كبيرة من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس ومسارات لإعادة دمجهم، وتعالج النقص في أفراد هيئة التدريس المؤهلين، وتقدّم دعماً إضافياً (بما في ذلك التعلّم الاجتماعي والعاطفي) لتهيئة بيئات تعليمية آمنة. ومن الأمثلة على هذه السياسات الاستراتيجية الوطنية العراقية للتربية والتعليم (2022-2031)، والخطة الوطنية لقطاع التعليم في الصومال (2022-2026)، والخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع التعليم في السودان (2018-2023)، وخطة التعليم الانتقالية في اليمن (2019–2022).  أطلقت معظم البلدان المتأثرة بالصراعات أو بحالات عدم الاستقرار في المنطقة خططاً لإعادة إدماج النازحين داخلياً في النظام التعليمي، وتوفير برامج تعلّم اجتماعي وعاطفي لمعالجة ما أسفرت عنه الصراعات من إجهاد وصدمات. وفي بعض الحالات، لم يكتمل تنفيذ الخطط التعليمية في مرحلة ما بعد الصراع بسبب قلة الموارد . وفي العراق، أعطت استراتيجية التخفيف من الفقر 2018-2022 الأولوية لدمج وتعليم أطفال الأسر النازحة داخلياً. وفي ليبيا ، شكّلت وزارة التربية والتعليم لجنة تعنى بشؤون النازحين والمهاجرين وتضع حلولاً محددة وفقاً لظروف الطلاب، والمعلمين، وموظفي الوزارة المتضررين. وفي الصومال، تكفل السياسة الوطنية بشأن اللاجئين العائدين والنازحين داخلياً الحق في التعليم، وتحدد الخطوات اللازمة لإنشاء أو توسيع نطاق الخدمات الضرورية لإيواء النازحين داخلياً، العائدين أو المدمجين. وشاركت وزارة التربية والتعليم في كل من من الجمهورية العربية السورية واليمن, في برنامج تنمية القدرات من أجل توفير التعليم التابع لليونسكو، الذي يؤمن التدريب على التعلّم الاجتماعي والعاطفي لمساعدة الأطفال على التغلب على ما أسفرت عنه الصراعات من إجهاد وصدمات. واتخذت منظمات أخرى مبادرات مماثلة في أجزاء من ليبيا.
أطلقت معظم البلدان المتأثرة بالصراعات أو بحالات عدم الاستقرار في المنطقة خططاً لإعادة إدماج النازحين داخلياً في النظام التعليمي، وتوفير برامج تعلّم اجتماعي وعاطفي لمعالجة ما أسفرت عنه الصراعات من إجهاد وصدمات. وفي بعض الحالات، لم يكتمل تنفيذ الخطط التعليمية في مرحلة ما بعد الصراع بسبب قلة الموارد . وفي العراق، أعطت استراتيجية التخفيف من الفقر 2018-2022 الأولوية لدمج وتعليم أطفال الأسر النازحة داخلياً. وفي ليبيا ، شكّلت وزارة التربية والتعليم لجنة تعنى بشؤون النازحين والمهاجرين وتضع حلولاً محددة وفقاً لظروف الطلاب، والمعلمين، وموظفي الوزارة المتضررين. وفي الصومال، تكفل السياسة الوطنية بشأن اللاجئين العائدين والنازحين داخلياً الحق في التعليم، وتحدد الخطوات اللازمة لإنشاء أو توسيع نطاق الخدمات الضرورية لإيواء النازحين داخلياً، العائدين أو المدمجين. وشاركت وزارة التربية والتعليم في كل من من الجمهورية العربية السورية واليمن, في برنامج تنمية القدرات من أجل توفير التعليم التابع لليونسكو، الذي يؤمن التدريب على التعلّم الاجتماعي والعاطفي لمساعدة الأطفال على التغلب على ما أسفرت عنه الصراعات من إجهاد وصدمات. واتخذت منظمات أخرى مبادرات مماثلة في أجزاء من ليبيا.
 تضطلع الجهات غير الحكومية ضمن هذه المجموعة من البلدان أكثر من بلدان المجموعات الأخرى بدور رئيسي في تعزيز النُّظُم التعليمية حيث القدرات قليلة، والطلب على بدائل لتقديم الخدمات كثير، والصعوبات كبيرة إزاء تنفيذ سياسات تعليمية متماسكة تتماشى مع الأهداف الإنمائية الطويلة الأجل. وفي الصومال، أدى ضعف المؤسسات التعليمية إلى خصخصة قطاع التعليم وسط حالة من انعدام الأمن طال أمدها. وحُرِم نصف الأطفال والشباب تقريباً من حقهم في التعليم بسبب عجزهم عن تسديد الرسوم. وفي الغالب، تتولّى المؤسسات الخاصة تقديم الخدمات التعليمية لنسبة 87.5 في المائة من طلاب المرحلة الابتدائية و91.5 في المائة من طلاب المرحلة الثانوية، في حين تسعى الحكومة إلى استعادة الإدارة العامة للقطاع. وأدّى هذا المسعى إلى نشوء "مدارس الإدارة المختلطة"، وأجج نزاعات حول ملكية العديد من المؤسسات.
تضطلع الجهات غير الحكومية ضمن هذه المجموعة من البلدان أكثر من بلدان المجموعات الأخرى بدور رئيسي في تعزيز النُّظُم التعليمية حيث القدرات قليلة، والطلب على بدائل لتقديم الخدمات كثير، والصعوبات كبيرة إزاء تنفيذ سياسات تعليمية متماسكة تتماشى مع الأهداف الإنمائية الطويلة الأجل. وفي الصومال، أدى ضعف المؤسسات التعليمية إلى خصخصة قطاع التعليم وسط حالة من انعدام الأمن طال أمدها. وحُرِم نصف الأطفال والشباب تقريباً من حقهم في التعليم بسبب عجزهم عن تسديد الرسوم. وفي الغالب، تتولّى المؤسسات الخاصة تقديم الخدمات التعليمية لنسبة 87.5 في المائة من طلاب المرحلة الابتدائية و91.5 في المائة من طلاب المرحلة الثانوية، في حين تسعى الحكومة إلى استعادة الإدارة العامة للقطاع. وأدّى هذا المسعى إلى نشوء "مدارس الإدارة المختلطة"، وأجج نزاعات حول ملكية العديد من المؤسسات. 
| لا تزال الفتيات يعانين من حرمان كبير في أجزاء كثيرة من المنطقة، حيث التقيّد بالأعراف والممارسات الاجتماعية يؤدي إلى عدم التحاق الفتيات بالمدارس، أو تسربهن بمعدلات أعلى من الفتيان. | في فلسطين ، وضعت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم للفترة 2017-2022، سعياً منها إلى إزالة الصور النمطية بين الجنسين، التي تؤثر سلباً على تدريب المعلمين، وإلى إعادة النظر في الفوارق بين الجنسين في المناهج والمواد التعليمية ا. | |
| يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة صعوبات في إمكانية وصولهم إلى بيئات التعلّم، وافتقار أفراد هيئة التدريس إلى التدريب اللازم لتلبية احتياجاتهم التعليمية. | وضعت الإمارات العربية المتحدة أنظمة لتحسين إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص التعليم، بطرق منها تجديد المباني المدرسية والفصول الدراسية، وتقديم خدمات التشخيص التربوي والتكنولوجيا المساعدة لدعم الاندماج في نظام التعليم العام، وتنشيط الدروس بلغة الإشارة وطريقة برايل، والالتزام بتكافؤ الفرص للطلاب الذين يعانون من إعاقة، وذلك بإتاحة فرص التعليم لهم في المؤسسة الأقرب إلى مكان إقامتهم ب. | |
| يواجه الأطفال الأشد فقراً عوائق متعددة تحول دون الحصول على فرص التعليم، بما في ذلك تكلفة اللوازم والرسوم المدرسية، ويتعرّضون لخطر إخراجهم من المدرسة ليعملوا ويعيلوا أسرهم. | في مصر، ساهم نموذج المدارس الأهلية في توسيع مظلة النظام التعليمي العام ليشمل الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في المناطق المحرومة التي تفتقر إلى المدارس العامة. وتتبع المدارس الأهلية نهجاً مرناً قائماً على تعدد الصفوف، وتجري إدارتها في شراكات بين وزارة التربية والتعليم، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات المحلية. ج وتسعى الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي إلى توسيع نطاق هذا النموذج ليشمل المدارس الفنية. د | |
| يواجه الأطفال في المناطق المتأثرة بالصراعات عوائق من جراء تدمير البنية الأساسية للتعليم، وتفاقم حالات النزوح، وتعرّضهم للصدمات. | في ليبيا ، سعت وزارة التربية والتعليم إلى زيادة فرص الالتحاق بالمدارس عن طريق إلزام المؤسسات التعليمية على جميع المستويات منح الطلاب النازحين فرصة التسجيل وإتمام عامهم الدراسي. واستفاد أكثر من 30,000 طفل من خدمتي المشورة والدعم النفسي الاجتماعي. | |
| غالباً ما يواجه يواجه اللاجئون والنازحون داخلياً صعوبات في الالتحاق بالمدرسة أو الحصول على الخدمات العامة، ولا يضمن العديد من البلدان حقهم في التعليم. | في المغرب، أتاحت الإصلاحات الأخيرة على مستوى السياسات للاجئين فرصة الالتحاق بالمدارس الوطنية ونُظُم التدريب. وأصبح أطفال اللاجئين والمهاجرين مؤهلين للاستفادة من برامج الأغذية، والحصول على خدمات النقل المدرسي ومخصصات الطلاب. | |
| يعاني الطلاب في المناطق الريفية والنائية للحصول على فرص تعليم جيد بسبب نقص المدارس، أو بعدها. | تعتمد الجزائر في سعيها للتغلب على الحرمان في المجتمعات الريفية برامج تقدّم منحاً دراسية للطلاب الملتحقين بدوام نهاري أو بدوام كامل (خاصة الذين ينتمون إلى أسر محرومة اقتصادياً). ويتيح التعلّم عن بعد من خلال المكتب الوطني للتعليم والتدريب عن بعد فرص التعليم للطلاب الذين يتعذّر عليهم الالتحاق حضورياً بالمدارس، من مرحلة ما قبل المدرسة حتى المستويات الثانوية. ه |


| النسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي المنفق على التعليم | النسبة المئوية للإنفاق الحكومي على التعليم | |
|---|---|---|
| المملكة العربية السعودية | 7.8 (2020) | 18.8 (2021) |
| تونس | 7.3 (2016) | 22.7 (2015) |
| الجزائر | 7.0 (2020) | 15.4 (2022) |
| المغرب | 6.8 (2020) | 16.9 (2021) |
| الكويت | 6.6 (2020) | 11.9 (2020) |
| عُمان | 5.4 (2019) | 12.2 (2020) |
| دولة فلسطين | 5.3 (2018) | 17.7 (2019) |
| العراق | 4.7 (2016) | 14.0 (2016) |
| الإمارات العربية المتحدة | 3.9 (2020) | 11.7 (2020) |
| الأردن | 3.2 (2021) | 9.7 (2021) |
| جيبوتي | 3.6 (2018) | 14.0 (2018) |
| قطر | 3.2 (2020) | 8.9 (2021) |
| مصر | 2.5 (2020) | 12.3 (2020) |
| جزر القمر | 2.5 (2015) | 13.4 (2015) |
| البحرين | 2.2 (2020) | 9.3 (2022) |
| موريتانيا | 1.9 (2020) | 10.4 (2022) |
| لبنان | 1.7 (2020) | 9.9 (2020) |
| الصومال | 0.3 (2019) | 4.4 (2021) |
| السودان | غير متوفر | 12.5 (2021) |



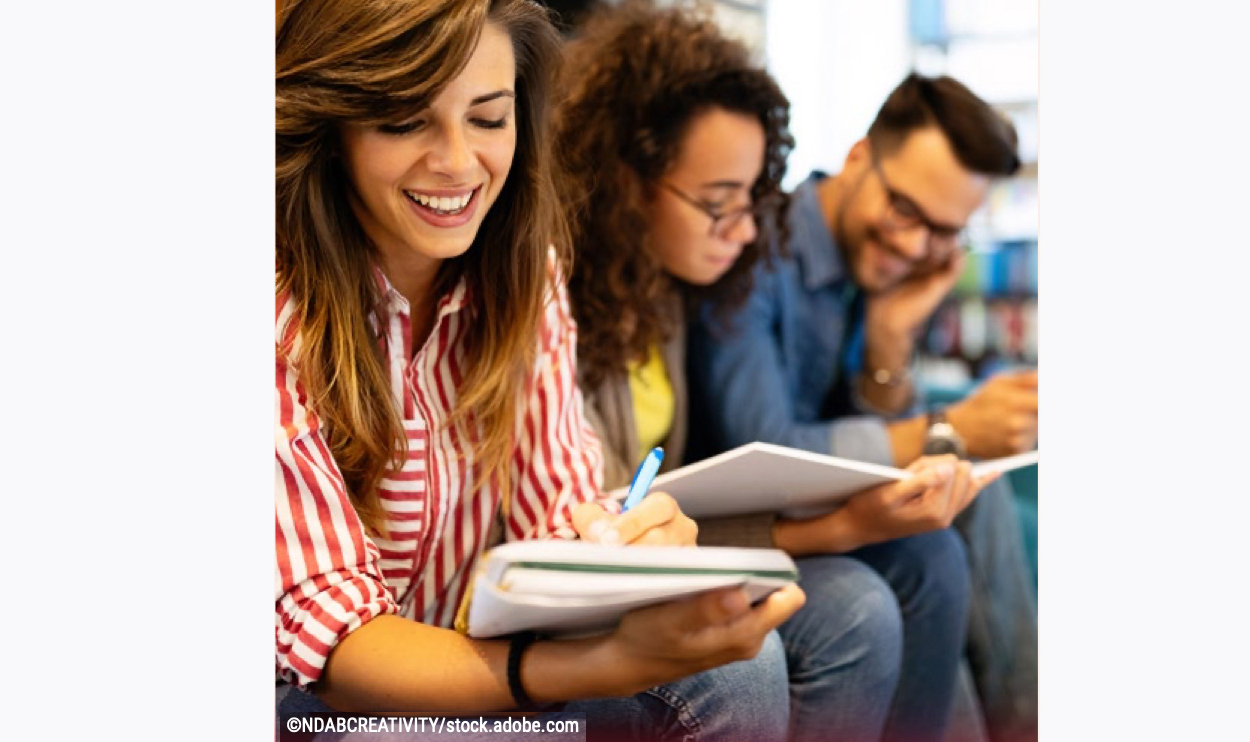

1. See UNESCO Institute for Statistics (UIS) data reported by the World Bank, Lower secondary completion rate (% of relevant age group), accessed in August 2023.
2. United Nations, 2019. . استُخدم تجميع "شمال أفريقيا وغرب آسيا" الإقليمي لإجراء هذه الإحصائية على النحو المحدد في التصنيف الإحصائي لرموز البلدان أو المناطق الإحصائية Standard Country or Area Codes for Statistical Use (M49).
3. See UNESCO UIS data reported by the World Bank, Compulsory education, duration (years), accessed on 29 March 2023.
4. UNESCO (2023b). يستند التحليل إلى الخطط التعليمية أو الوثائق المماثلة المعتمدة في كل من الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والجزائر، والجمهورية العربية السورية، والسودان، والعراق، وعُمان، ودولة فلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، والمملكة العربية السعودية، واليمن.
5. See the UNESCO online dashboard, Global monitoring of school closures caused by COVID-19; تضم المجموعة الإقليمية المشمولة بهذه الدراسة "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وإيران، والبحرين، وتونس، والجزائر، والجمهورية العربية السورية، وجيبوتي، ودولة فلسطين، والسودان، والعراق، وعُمان، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، واليمن.
6. See UNESCO UIS data reported by the World Bank, School enrollment, primary and secondary (gross), gender parity index (GPI) – Arab World, World , accessed in March 2023.
7. ESCWA, 2019.
8. أجري التحليل استناداً إلى UNESCO education policy profiles on the theme of inclusion, accessed on 4 April 2023.
9. UNESCO, 2022b.
10. UNESCO, 2021.
11. Waterbury, 2019.
12. Karakhanyan, 2019.
13. المرجع نفسه.
14. أجري التحليل استناداً إلى the UNESCO TVET country profiles, accessed on 30 March 2023.
15. Boyle and Ramos-Mattoussi, 2018.
16. استناداً إلى بيانات عام 2022 عن اللاجئين التابعين للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وللأونروا، والنازحين داخلياً المشمولين باختصاص مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمبلّغ عنهم في أداة البحث عن بيانات اللاجئين UNHCR refugee data finder.
17. UNESCO, 2019a.
18. Haqqi Consortium, 2023.
19. ESCWA, 2021.
20. يمكن الاطلاع على مقارنة لنتائج الاختبارات في ESCWA, 2022, p. 101.
21. ESCWA, 2021.
22. الإمارات العربية المتحدة، وزارة التربية والتعليم، الارتقاء بمستوى النظام التعليمي.
23. Oman’s National Strategy for Education 2040, executive summary.
24. Al-Fadala, n.d.
25. 2020 ,Alhouti and Alhashem.
26. Al-Fadala, n.d.
27. UNESCO, 2023a.
28. الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول التعاون في مجال التعليم، استُرجع في 4 نيسان/أبريل 2023.
29. Gulf Research Centre on the Percentage of nationals and non-nationals in Gulf populations (2020).
30. UNESCO, 2019b.
31. في هذا التحليل تشمل البلدان المتوسطة الدخل الأردن، وتونس، والجزائر، والعراق، ودولة فلسطين، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب.
32. UNESCO education policy profiles, accessed on 5 April 2023.
33. يمكن الاطلاع على صفحة "معلومات مفيدة" على الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، معلومات للاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية.
34. UNESCO education policy profiles, accessed on 5 April 2023.
35. في هذا التحليل تشمل البلدان المتأثرة بالصراعات والهشة الجمهورية العربية السورية، والسودان، والصومال، والعراق، ودولة فلسطين، ولبنان، وليبيا، واليمن.
36. UNICEF, 2015.
37. UNESCO, 2022d.
38. See the UNESCO education policy profile, the Sudan, accessed on 5 April 2023.
39. See the United Nations MPTF Office Partner Gateway, A Triple Nexus Approach in Syria.
40. Swiss Agency for Development and Cooperation, 2022.
41. ESCWA, 2022.
42. UNESCO and World Bank, 2022.
43. المرجع نفسه. يستند التحليل إلى بيانات من الأردن، وتونس، والسودان، والعراق، وعُُمان، ودولة فلسطين، ولبنان، ومصر، والمغرب.
44. UNESCO, Financing Education, accessed on 22 June 2023.
45. UNICEF, 2023.
46. UNICEF, 2017.
47. UNESCO, 2022a.
48. European Commission, 2019.
49. Riddell, 2012.
Al-Fadala, A. (n.d.). K-12 Reform in the Gulf Cooperation Council (GCC) Countries: Challenges and Policy Recommendations.
Alhashem, F., and I. Alhouti (2020). Endless education reform: The case of Kuwait. Annual Review of Comparative and International Education.
Boyle, H., and F. Ramos-Mattoussi (2018). Arab Barometer Report on Nonformal Education in the MENA Region.
Cacich, M., and F. Aboudan (2022). Accreditation, certification and recognition of non-formal education in the Arab States. UNESCO World Education blog.
Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) (2019). The Arab Gender Gap Report 2020: Gender Equality and the Sustainable Development Goals.
__________ (2020). Reforming Technical and Vocational Education and Training: A Gateway for Building a Skilled Youth Workforce in the Arab Region.
__________ (2021). Quality of Education: Measurement and Implications for Arab States.
__________ (2022). Social Expenditure Monitor for Arab States: Towards Making Budgets More Equitable, Efficient and Effective to Achieve the SDGs.
European Commission (2019). Erasmus+ Higher Education Impact Study. European Union.
European Training Foundation (2021). Policies for Human Capital Development, Southern and Eastern Mediterranean Region: An ETF Torino Process Assessment.
Haqqi Consortium (2023). Impact of Remote Learning Modality on Non-Formal Education: Supporting the Right to Quality Education for Vulnerable Syrian and Host Community Children and Youth.
International Labour Organization (ILO) (2020). ILO and Jordan’s TVSDC Collaborate to Re-engineer Core Services for Better Quality. Geneva.
International Labour Organization (ILO), United Nations Children’s Fund (UNICEF), and European Training Foundation (2023). Enabling Success: Supporting Youth in MENA in Their Transition from Learning to Decent Work.
Karakhanyan, S. (2019). Quality assurance in the Arab region in the era of customization: Where do we stand in terms of relevance? In *Major Challenges Facing Higher Education in the Arab World: Quality Assurance and Relevance*.
Riddell, A. (2012). The effectiveness of foreign aid to education – What can be learned? Working Paper No. 2012/75. United Nations University, World Institute for Development Economics Research.
Swiss Agency for Development and Cooperation (2022). A Learning Journey on the Triple Nexus.
United Nations (2019). SDG Report 2019: SDG 4. New York.
United Nations Children’s Fund (UNICEF) (2015). Conflict drives 13 million children out of school in the Middle East and North Africa.
__________ (2017). Reimagining Life Skills and Citizenship Education in the Middle East and North Africa.
__________ (2019). A World Ready to Learn: Prioritizing Quality Early Childhood Education, Global Report.
__________ (2021). Situational Analysis of Women and Girls in the Middle East and North Africa: A Decade Review (2010-2020).
__________ (2023). Transforming Education with Equitable Financing.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2019a). Migration, Displacement and Education: Building Bridges, Not Walls. Global Education Monitoring Report, 2019: Arab States.
__________ (2019b). International and Other Migrant Schools in Gulf Cooperation Council Countries.
__________ (2021). Right to Pre-primary Education: A Global Study.
__________ (2022a). Implementing National Qualifications Frameworks: Monitoring Quality and Relevance in Bhutan.
__________ (2022b). Promoting the Inclusion of Children and Young People with Disabilities in Education in the Arab Region: An Analysis of Existing Developments, Challenges and Opportunities.
__________ (2022c). Why Early Childhood Care and Education Matters.
__________ (2022d). With UNESCO, Yemen Is on Its Way to Collect Data on Education.
__________ (2023a). Oman Embarks on Development of K-12 AI Curricula with Support of UNESCO and RCEP.
__________ (2023b). Survey of Policies for SDG4 in Arab Countries (Arabic).
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and World Bank (2022). Education Finance Watch 2022.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), United Nations Children’s Fund (UNICEF), and World Bank (2021). COVID-19 Learning Losses: Rebuilding Quality Learning for All in the Middle East and North Africa.
Waterbury, J. (2019). Reform of Higher Education in the Arab World: Major Challenges Facing Higher Education in the Arab World—Quality Assurance and Relevance.
World Bank (2015). MENA Regional Synthesis on the Teacher Policies Survey: Key Findings from Phase 1.