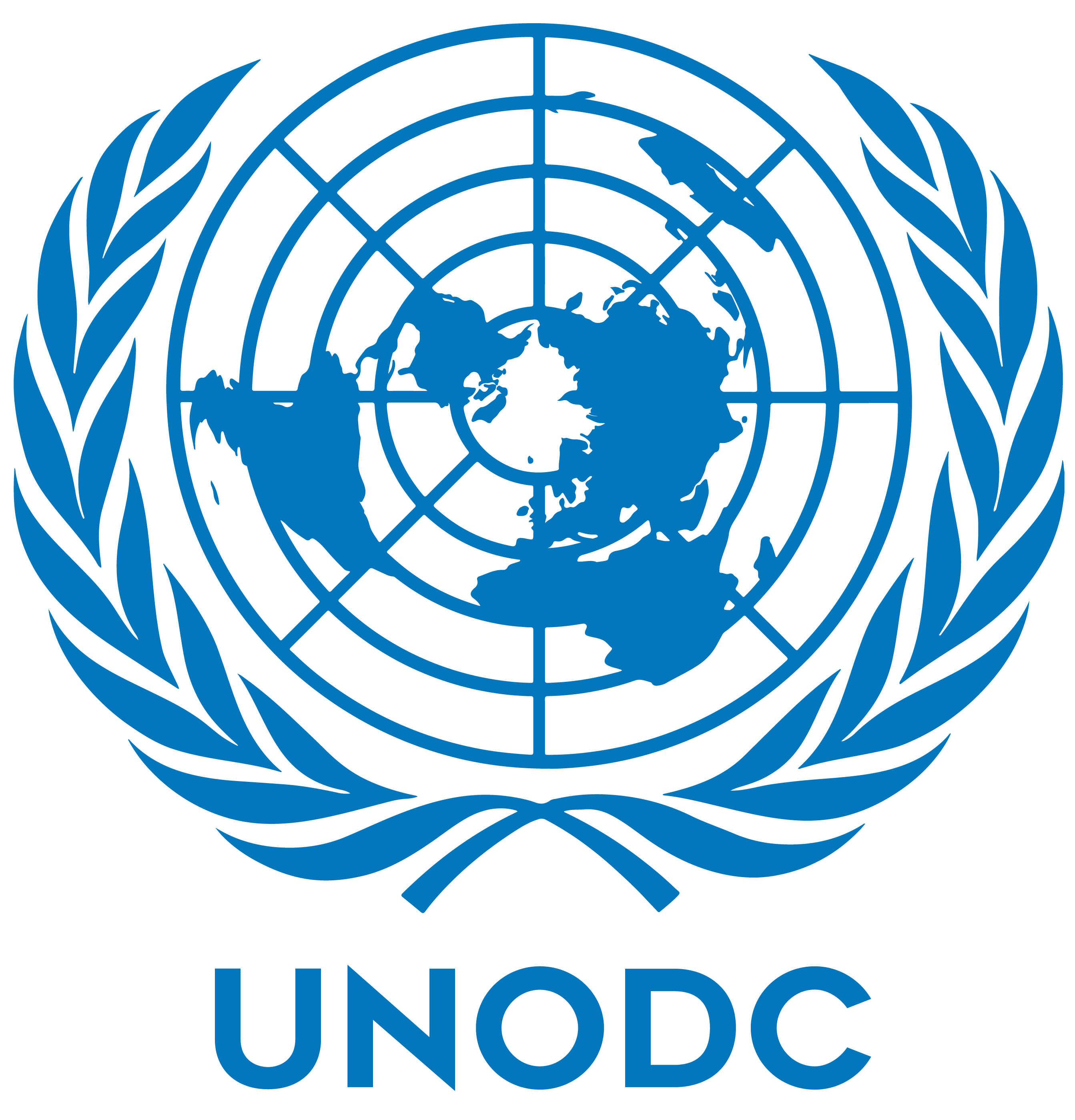الهدف 1: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان
لم تحرز المنطقة العربية التقدُّم اللازم على مسار القضاء على الفقر بجميع أشكاله بحلول عام 2030. وقد ازداد، في العقد الماضي، عدد الفقراء والمعرضين لخطر الفقر. وعلى الرغم من أن الفقر المتزايد بلغ أعلى مستوياته في أقل البلدان نموًا، إلا أن عدم الاستقرار السياسي، ونشوب الصراعات، ونشوء الأزمات الاقتصادية، أدت جميعها إلى تفاقمه في جميع أنحاء المنطقة. وتشكِّل عوامل مثل التحديات الهيكلية الدائمة التي تواجهها اقتصادات المنطقة، وضعف الأداء في النمو وفي استحداث فرص العمل، وارتفاع مستويات عدم المساواة، وعدم كفاية سياسات إعادة التوزيع المالي، عقبات أمام تحقيق النمو الشامل الذي يضمن عدم إهمال أحد، ويرفد التقدُّم المستمر نحو القضاء على الفقر.والتصدي للفقر مسيرة شائكة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتقدم على مسار تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ككل. القضاء على الفقر على نحو مستدام يتطلب من البلدان العربية تحقيق نمو اقتصادي شامل يأتي بفرص العمل اللائقة للجميع (الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة)، وعكس التوجهات المتسارعة نحو تركيز الثروة التي تجعل من المنطقة أقل مناطق العالم مساواة (الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة)، وإزالة العوائق التي تسهم في تأنيث الفقر (الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة)، وتهيئة بيئات مؤسسية شاملة تمكِّن من تحقيق السلام والازدهار (الهدف 16). ويتطلب السعي إلى الحد من الفقر على نحو مستدام التصدي للعوامل غير النقدية المساهمة في الفقر، وذلك من خلال الشروع في الإصلاحات التي تضمن الحصول على التعليم الجيد (الهدف 4)، ووضع السياسات الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والصحة الجيدة (الهدفان 2 و3)، وتأمين الاستثمارات لتوسيع نطاق فرص الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الحصول على خدمات المياه النظيفة والصرف الصحي (الهدف 6)، والطاقة النظيفة بكلفة ميسورة (الهدف 7)، والسكن الجيد (الهدف 11).

ما تقوله البيانات
وصولاً إلى عام 2030: نُهُج السياسات المقترحة لتسريع التقدم في تحقيق الهدف 1
- ■ تطوير قدرات وشفافية نُظُم جمع البيانات، بطرق منها زيادة التركيز على التصنيف حسب الجنس، والموقع، والعمر، والإعاقة، وحالة الهجرة، وغيرها من الخصائص ذات الصلة.
- ■ اعتماد قياس متعدد الأبعاد للفقر وجمع البيانات بانتظام لضمان فهم قضايا الفقر والحرمان بشكل شامل.
- ■ زيادة وتيرة جمع البيانات لضمان توفرها على أساس آني بهدف الاسترشاد بها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات.
- ■ تعزيز صنع السياسات المتكاملة من أجل التصدي للعوامل التي تسهم في تفاقم الفقر المتعدد الأبعاد، بما في ذلك أوجه القصور في الحصول على التعليم الجيد، والتغطية الصحية، وخدمات المياه والصرف الصحي، والسكن الجيد، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات من هم الأكثر تعرضاً للإهمال.